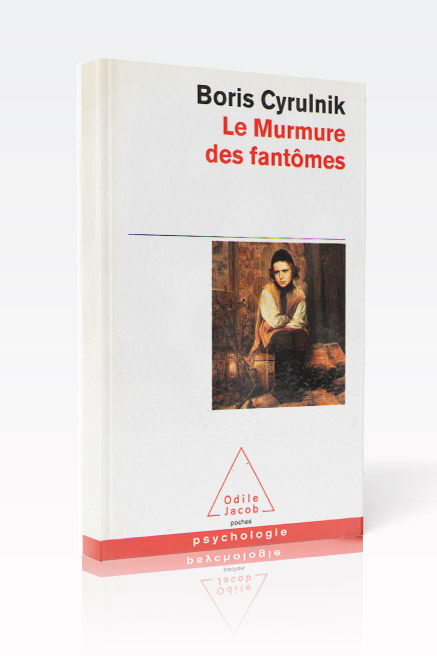تبقى مخزنة في ذاكرته.. كيف تجعل صدمة الطفل في طفولته أداةً لعلاجه؟
التحرر من صدمات الماضي شرط لاستعادة الأمان العاطفي. وعلى عكس ما يُظن، يحمل الأطفال الصغار ذكريات دقيقة عن تجاربهم. لكن، بما أنه يستحيل تذكر كل شيء، يكتفون بالاحتفاظ بصور عما أثار لديهم انطباعاً عميقاً.
وفي هذا الكتاب «همس الصدمات»، يحكي لنا الباحث الشهير د. بوريس سيرولنيك، عن ضجيج الصدمات الذي يتحول إلى همس، أو صدى، يظل يتردد من الطفولة حتى سنّ الرّشد، وفي سياق العلاقات العاطفية والاجتماعية التي ينسجها المرء في حياته.
فبالنسبة إلى الطفل الباريسي، على سبيل المثال، البالغ من العمر ثلاث سنوات، لن يحتفظ بأي ذكرى عن الحرب في أفغانستان، أو عن انتصار فريق كرة القدم الوطني في المباريات العالمية، بل ستشكل العادات التي تسبق النوم، أو زيارة جدّته في يوم العطلة، عنصراً مثبتاً لعالمه الذهني، ما يجعله ينتظر تكرار هذه العادات. لكن في حال شكّل انتصار الفريق الوطني عاملاً مزعزعاً لتلك العادات اليومية الراسخة، كسر لمرة أو أكثر تكرارها الرتيب، فإن هذا سيعطيه إحساساً بالحدث، أي أن الانفعال هو الذي سيسمح بخلق الذكرى.
الصدمات تُخزن في ذاكرة الطفل
تعتبر ذاكرة الأطفال في سنّ الثالثة على درجة التنظيم ذاتها التي تتمتع بها ذاكرة الأطفال بين سنّ العاشرة، والثانية عشرة، مع فرق بين العادات الروتينية، والأحداث البارزة. فالطفل في الثامنة يروي، بدقة، ذكرى رحلته الأولى في الطائرة، حين كان في الثالثة من العمر، شرط أن يكون أهله جعلوا منها انفعالاً محفِّزاً. وحتى أن طفلاً في الثانية من العمر، يمكنه أن يتعرف إلى لعبة قام بها قبل عام، وأثارت ضحكاً شديداً من حوله.
وينسى الكبار كم أن ذاكرة الطفولة لديهم تتمتع بالموثوقية، بالطبع هي تتحوّل إلى صور مع الزمن، وبالأخص مع المراجعات، ويزول عنها الطابع العاطفي، فنحن نتذكر صورة الحدث كحكاية يتم تمثيلها بصمت، وننسى شيئاً فشيئاً الانفعال الذي رافقها، علماً بأن الانفعال ذاته هو الذي جعل منها ذكرى.
يتعرض الأطفال الذين يصابون بالصدمات قبل أن يتمكنوا من الكلام، أو الذين تُساء معاملتهم، أو يهجرهم أهلهم، لاضطراب في انفعالاتهم، فهم ينتفضون، مثلاً، عند سماع أقل ضجة، ويعبّرون عن هلعهم عند أي انفصال، ويخافون أمام أي جديد، ويسعون إلى تجميد أحاسيسهم حتى يشعروا بمعاناة أقل. فالتعديلات الدماغية التي تسببت بها الصدمة تحول دون السيطرة على الانفعالات، وتجعل الطفل عرضة للتشوُّش السريع.
وفي هذه المرحلة من النمو، يتسبب أي حدث مشحون بالانفعال، بفوضى حواس تمكننا من فهم لماذا يدرك الطفل أولاً كل ما يُذكّره بالاعتداء، سواء أكان التكلم بصوت عالٍ، أم بطريقة شديدة التوكيد. ويتأقلم الطفل مع رؤية العالم التي انطبعت في ذاكرته البيولوجية، ويستجيب لها. ويرد بطريقة عدائية لأنه صار يخاف أو يهرب في حالة من يريدّ أن «ينقذ جلده» بأي ثمن.
وتقتضي استراتيجية المرونة لاستعادة النفس تعلّم كيفية التعبير عن الانفعالات بطريقة مغايرة. فالعمل المنسق والتعبير السلوكي، التصويري أو الكلامي، عن عالمه الداخلي يمكّنان الطفل من استعادة السيطرة على انفعالاته.
وهكذا تمتلئ الحياة النفسية بعد الصدمة بنُتَفٍ من الذكريات التي ينبغي بواسطتها إعادة بناء ماضينا، كما تمتلئ بحساسية مفرطة مكتسبة إزاء نوع من العالم، سيشكل معياراً لفهم حياتنا. بأيّ لَبِنات مستخرجة من الواقع سنستمر في تشكيل ذكرياتنا؟ بأيّ كلمات سنحاول أن نستعيد مكاننا في عالم البشر؟
الطفل الذي تعرّض لاعتداء ما، في مرحلة ما قبل اكتساب الكلام، لن يتمكن بالتالي من القيام بالعمل النفسي ذاته، كالطفل الذي تعرّض لصدمة في مرحلة يستطيع فيها أن يقولبها بالكلام. وحين يحصل التمزق قبل ظهور الكلام، ينبغي أن نصلح البيئة المحيطة قبل أن «نعيد خياطة»، الطفل. أما في حال جُرِح الطفل بعد اكتسابه الكلام، فسيتوجب العمل على إعادة تمثيل، أو تصوير ما حصل معه.
الشحنة التي تعيد ذكرى الصدمة إلى الطفل
كل ذكرى تجعل كلّ منّا إنساناً جديداً، بما أن كل حدث يشكل لبِنة من الذاكرة، ويعدِّل الصورة التي نحملها عن أنفسنا. ويعتبر هذا البناء حامل أمل، لأن الذكريات تتطور مع الزمن، ومع الحكايات. لكن العالم الداخلي للمصدوم يعتمد كذلك على العالم الداخلي للشخص الذي يفضي إليه بمشكلته، وعلى الشحنة العاطفية التي ينسبها الخطاب الاجتماعي للحدث الصادم. ما يعني أن الطريقة التي يتحدث بها الجميع عن الصدمة تساهم في الصدمة، فإما أن تبلسمها، وإما أن تزيدها حدّة.
إن كل كلام يدّعي إلقاء الضوء على جزء من الواقع. ولكنه بهذا يحول الحدث بما أنه يهدف إلى إيضاح شيء سيظل مشوشاً من دونه، أو أنه سيظل في حيز الإدراك من دون التصوير. فأنْ نقول ما حصل يعني أننا نفسّره، أي أننا نعطي معنى لهذا العالم المضطرب، ولهذه الفوضى التي لا نفهمها جيداً، ولم نعد قادرين على التعاطي معها. يجب أن نتكلم حتى نعيد ترتيب الأمور، ولكن حين نتكلم نفسر الحدث، وهذا ما يمكن أن يوجهه نحو ألف اتجاه مختلف.
وإلى جانب صور دقيقة جداً ولكن محاطة بضباب، يضاف مصدر آخر للذاكرة، وهو سيناريوهات الذكريات التي يأتي بها الكلام. فذكريات صور أطفالنا تظهر حتى قبل أن يكونوا قادرين على الكلام. وهي تتمتع بدقة عالية، تفوق دقة ذكريات الكبار، ولكنها تعبّر عن وجهة نظر الطفل. كل واحد يراقب العالم من المكان حيث يكون، ولا يرى فيه الصور ذاتها، لكنها جميعها حقيقية. وهي تبقى محفورة في ذاكرة الطفل، ولكن حين تصير القصة مشتركة مع شخص بالغ، يصير الانفعال المصاحب للصورة معتمداً على الطريقة التي نتحدث بها عن الذكرى مع هذا البالغ.
دعونا نلعب لعبة «القراصنة» مع مجموعتين من الأطفال يبلغون من العمر خمس سنوات. يقضي الاختبار أن نلعب مع مجموعة لا نعطيها سوى تفسيرات وتعليمات باردة: «سنمضي خلف المقعد»، «سنرفع اليد التي تمسك بالسيف»، «سنفتح العلبة».
أما مع المجموعة الأخرى، فإننا سوف نشحن التعليمات ذاتها بالانفعالات: «أحمل سيفي القاطع»، «أهجم على القراصنة الأشرار»، «ماذا أرى؟ أهو صندوق مملوء بالمجوهرات والذهب؟»، بعد بضعة أشهر، نجتمع مجدداً بفريقي الأطفال، ونطلب منهم أن يلعبوا السيناريو ذاته الذي لعبوه في المرة الأولى. سنجد أن الفريق الذي سمع كلاماً مشحوناً بالانفعالات، استعاد العديد من الذكريات، في حين أن الفريق الذي شرحنا له اللعبة ببساطة لم يسترجع سوى نتفٍ منها.
في الحالتين، الذكريات حاضرة، لكن الطريقة التي تعيش بها مختلفة. ذكريات هذه اللعبة ستشكل لبنة هوية لدى كل طفل، لكنها ستكون مختلفة بحسب الطريقة التي حدثهم بها المحيطون بهم. ويفسر اختزان الذكريات هذا السبب الذي يجعل من الصدمات ذكريات مضيئة بالنسبة إلى البعض، في حين أنها ضبابية بالنسبة إلى البعض الآخر.
الصدمة المزمنة في ذاكرة الطفل
إذا كانت ذكرى الصدمة واضحة، فهذا يعني أن الحدث كان بارزاً، وأن المحيطين بالطفل قد تحدثوا عنه بوضوح. وعندما تُحدث الصدمة ثغرة، يضطرب العالم الداخلي إلى درجة أنه يفقد مرتكزاته. وجرت عودة نصف مليون جندي أمريكي من فيتنام بعد انتهاء الحرب فيها، بشكل سيئ للغاية. فالحرب لم تشكل محنة كبيرة وحسب، لكن المعارك لم يكن لها أي معنى بالنسبة إلى أغلبية هؤلاء الشبان الذين كانوا يتساءلون عما يفعلونه هناك. وبعد أن سقطت سايغون بأيدي الفيتكونكغ، تم الانسحاب بشكل مرتبك جداً، وكان مملوءاً بالصراخ والإهانات والمظالم.
كما كانت العودة بمثابة محنة إضافية بالنسبة إلى هؤلاء الرجال المنهكين الذين مروا بأهوال لا معنى لها بالنسبة إليهم. وشعروا بأنه يُنظر إليهم كحثالة من قبل شعبهم الذي لم يستقبلهم كـ«أبطال» حرب، بل جوبهوا باتهامات تجعل منهم مجرمين. اجتمع كل شيء حتى تنحفر صور الأحداث في ذاكراتهم لتصير صدمة، أشارت بعدها الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد الوفيات العنيفة، من انتحارات وعمليات قتل بين قدامى الجنود الأمريكيين، كانت أكبر عدداً، مما كانت عليه إبان الحرب ذاتها.
وحين تكون الصدمة مزمنة، يكون الحدث أقل بروزاً، بما أن الخدر قد أصابه بسبب الحياة اليومية. وحين يسعى المعتدى عليه إلى أن يشعر بإحساس أفضل، ويحتاج إلى إصلاح صورة المعتدي الذي هو مرتبط به، تبدل ذاكرته إيحاءاته العاطفية. وكثيرون هم الأطفال المساءة معاملتهم الذين يحتفظون بذاكرة غاية في الدقة، عن بعض مشاهد العنف الذي تعرضوا له، لكن أطفالاً آخرين مثلهم، يؤكدون تماماً أنه لم يتم الاعتداء عليهم البتة، على الرغم من ذهول الذين شهدوا حوادث الاعتداء تلك.
لا تعمل كلمات الكبار وحدها على تثبيت الصور في ذاكرة الأطفال، لكن كل الأحكام الثقافية المسبقة كذلك، فالصور النمطية التي نكررها آلاف المرات تبني صورة للبيئة الكلامية لدى الطفل، وتسهم في تشكيل الذكريات الأكثر صدقاً. في الولايات المتحدة، كل الأطفال المخطوفين يؤكدون أن من خطفهم رجل «أسود»، وحين يتم القبض على الخاطف، كثيراً ما يتبين أنه رجل «أبيض».
اقرأ أيضاً: لماذا تعرضنا الصدمات والأزمات النفسية للإصابة بالبدانة؟