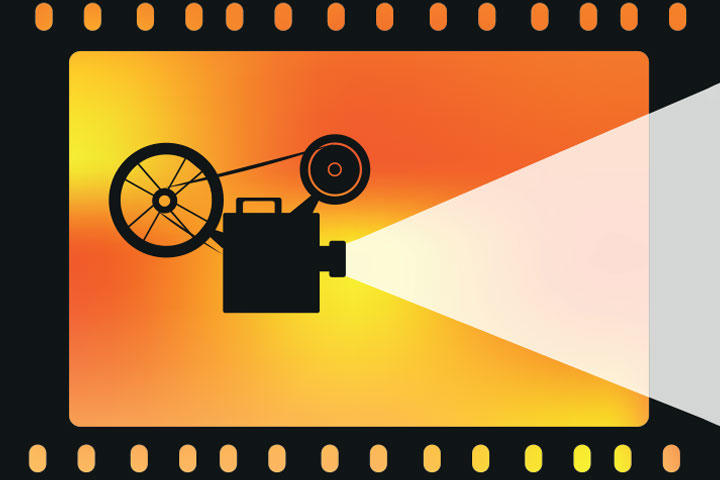
إذ ينعي البعض النقد السينمائي العربي على أساس أنه كان موجوداً في فترة ما والآن لم يعد له وجود، فإن المرء يتساءل عما يمكن أن نسمي النقد الموجود بيننا.
هناك نقاد بالتأكيد وهؤلاء يكتبون على نحو جاد وهادف ويعكسون ثقافة سينمائية كبيرة ومحتوى أساسياً يعكس المعرفة وحسن التواصل مع الآخرين. فإذا لم يكن ما يكتبه هؤلاء نقداً فما هو؟ هل هم بائعو فول وطعمية مثلاً، أو يعملون في مطاعم فلافل؟ هل يبيعون البطاطا والبندورة؟ أو يعملون في الذهب والفضة؟
مع كل الاحترام لأصحاب هذه المهن، الناقد موجود ولا يجيد بيع أي شيء. هم ليسوا تجاراً بل كتّاب ثقافة سينمائية معظمهم مهموم بواقع التردي الثقافي والسينمائي والفني عموماً.
صحيح أن هناك فوضى كبيرة في حياتنا الفكرية. مثلاً، كل واحد صار ناقداً على النت لمجرد أن لديه رأياً يبديه. كل شخص بات مخرجاً عالمياً لأن فيلمه عرض في مهرجان لم يسمع به أحد. كل ممثل صار «نجم الجمهور» لنجاح فيلم واحد له تجارياً. أليست هذه فوضى؟
الإنجازات التقنية في السنوات العشرين الماضية رائعة وتخدمنا على أكثر من صعيد. لكن هناك جوانب سلبية كثيرة تتسلل من خلالها إلى المفاهيم. ماذا يعني أن طفلاً في الخامسة لديه هاتف صغير يتسلى به؟ ولماذا عند الدخول إلى قطارات «الأندرغراوند» أو عند صعود الحافلات يمشي البعض رويداً رغم الزحمة لأنه يبحث في هاتفه عن صورة أرسلت إليه (أو إليها)؟ ثم ماذا عن ذلك الذي يعترف بأنه لم يقرأ كتاباً واحداً خلال السنوات العشرين ذاتها؟ أو ذاك الذي يقول لك إنه لم يعد يعرف كيف يعيش من دون تقنيات اليوم؟ أليست هذه فوضى؟
هذه ليست أمثلة بل مشاهدات. ليست مجرد نماذج بل وقائع. فوقها حقائق مقلقة عن محاولة تسييس المثلية وفرضها على المجتمعات المحافظة. طرد لاعب مصري من ناد إسباني لأنه رفض الموافقة على ترويجها. أشخاص في الغرب يجرون عمليات تغيير جنسي ثم يعترفون بالخطأ (حدث ذلك في الشهر الماضي في إيرلندا) ومنع الكتب الدينية من بعض المدارس الغربية بدافع حرية التعبير.
فوق ذلك، هناك ذلك الإنجاز المقلق: صندوق عجب يستطيع أن يكتب مقالتك أو كتابك أو السيناريو الذي لا تستطيع كتابته بمفردك وما عليك سوى كتابة اسمك عليه وتقبض الثمن.
هي فوضى فعلاً خصوصاً إذا ما شطح المرء وتناول كل ما يعج به العالم اليوم من حالات وظروف ومشاكل تسودها كل قليل مشاكل أخرى ما يغطي على تلك السابقة.